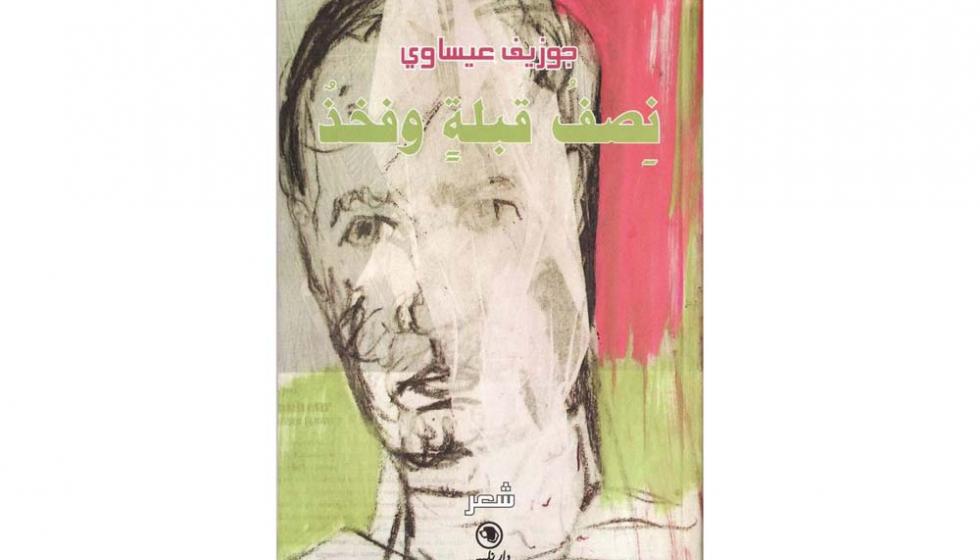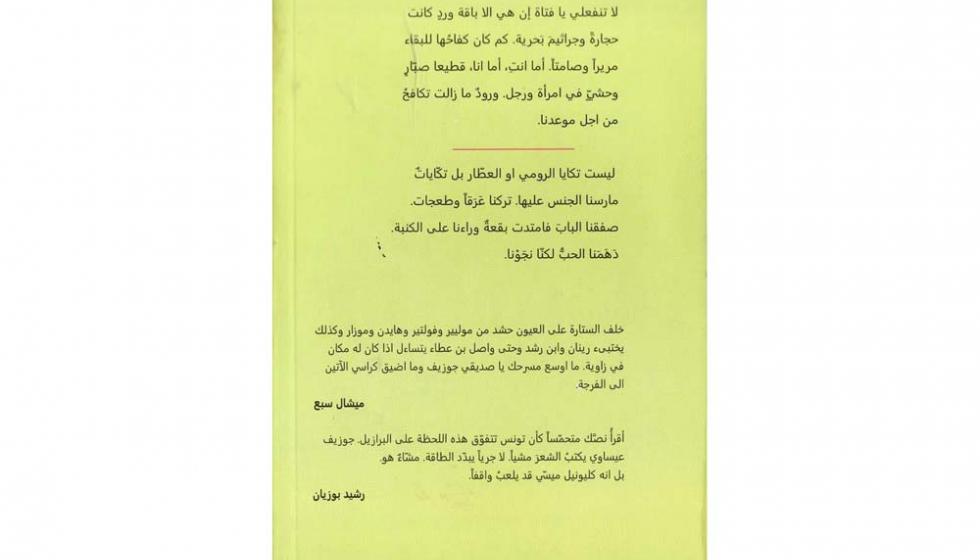"نصف قبلة وفخذ" لجوزيف عيساوي: إثارة جميلة في كوب حبر
"نصف قبلة وفخذ" (دار نلسن)، آخر إصدارات الشاعر والصحافي جوزيف عيساوي، بنصوص قصيرة، معاصِرة في عرضها وأفكارها، حيث تناقش مختلف المواضيع المطروحة على الساحتين الثقافية والاجتماعيّة، بدءا من تأخّر حال اللغة العربية، وصولا إلى التكنولوجيا وأثرها، وليس بعيدا عن الحب الحقيقي والجسد المتحرّر.
نصوص "عيساوي" تعبّر بعمق عن تجربة الذات ما يوحي بالواقعيّة، وبالتجربة الشخصيّة، نظرته إلى العالم وعلاقته بمحيطه، حيث تنتشر الأفعال بصيغة الأنا، على طول الديوان، وفي أحيان أخرى، يكون الحديث على لسان أجزاء من جسده. وكأنّ الكاتب ينفرد بنفسه لينثر تأمّلاته كلمات، تعبّر عن موقف هنا وإحساس هناك، في لحظات صفاء بحتة، حين يجد الإنسان نفسه مجرّدًا من كل شيء إلا من صوت داخله، وهنا تكون الحقيقة الكاملة والوحيدة.
ولغلبة فعل الأنا على الديوان دلائل كثيرة، إذ تكون تجربة الكاتب هي تجربة كل إنسان، ليجد القارئ همومه واهتماماته في نصوص كثيرة، وكأنه هو مَن يكتب ليعبّر عن حالة عاشها، فيلتقي مع الكاتب في أحاسيس كثيرة.
بدءا من "أكتب"، تلك الافتتاحيّة التي تذهب مباشرة إلى أزمة اللغة العربية "جلست كسرة على كرسيّ الفتحة. لعبت سكون وفتحة لعبة خاتم وإصبع". وإن كان ظاهرها فنيًّا، إلا أنّ الكلمات تظهر مراد الكاتب، وتحمل في طيّاتها طرحًا لما تعانيه اللغة من ضعف وتراجع، خاصّة عندما يدعو الحروف "لتنهض من نومها في الضحى". وللطبيعة مكانها ومكانتها مع "بيت الرعد" حيث تبرز العظمة من عناق قمم الجبال للنسور تحت عين الشمس وبلفحات من الهواء.
"نافذة"، "مسمار"، "غرفة غافية"، "الذكرى"، "سعادة"، "أشربكِ"، "نسمات"، "شهود"... وعناوين أخرى، شكّلت مجتمعة نصوص الديوان، تطغى عليها الكلمة المفردة، وهو اقتصاد في الكلمات يعتمده العيساوي وفق ما يقتضي الموقف، تتخلّلها رسومات تحاكي النص تأمّلا ومعنى، للتعبير عن عدد لا يحصى من المشاعر الشديدة، التي ولّدتها ساعات التأمّل والانفراد بالذات. حيث يسعى النثر إلى جعل الخبرة شفافة ومنظمة وغنيّة بالأحاسيس.
انعكاسات المجتمع هي نقطة جيّدة لبدء نقاشنا حول التناقض العاطفي الذي يضيف بعدًا دراماتيكيًّا للنص. إذ، في ظلّ زحمة العالم الجديد، يمكننا أن نتذكر كل اللحظات التي واجهنا فيها انقطاعا بين الطريقة التي كان من المفترض أن نشعر بها وكيف شعرنا. وعندما تفسح الكلمات مجالا للحدث الذي تنسجه المشاعر، كي يبرز، لا يقتصر الأمر على إثارة موضوع قديم أو حديث، أو كيف كان وكيف يجب أن يكون، ولكنه يفوز بالقارئ من خلال الوعد برواية الحقيقة، حقيقة المشاعر ونقيضها، ليبرز عدد لا بأس به من معالم الحياة من خلال الضغوطات، سواء العاطفية أو العقليّة، أو العمليّة. وإذ نشير إلى عجزنا الخاص كأناس عاديّين، كما يتفق فرويد والأخوان جريم، على الرغم من أن جميع العلاقات الحميمة لها متع أخرى: الرغبة الحسية، والخوف من الانفصال، والخوف من الموت، والغضب من الحبيب... والآن بعد أن اصطدم هذا الإنسان بالواقع، تمّ كسر حلمه المثالي، وفقد قطعة منه، ما عرّض توازنه للخطر.
هذا الخطر، يتخطّاه الكاتب بجرأة كبيرة، حين يفلت العنان للشهوة الجسديّة، والإثارة الحسيّة، ذاكرًا الأشياء بأسمائها وبأفعالها، متخطيًّا حواجز كثيرة، بتعابير هي أقرب إلى الحب، الجنس، الجسد، الذات، الحب، الأعضاء، العلاقة... منها إلى الترميز والإيحاء، ما يفسّر جماليّتها.
أمثال بعض الشعراء المشهورين الذين حوّلوا الواقع حكايات مألوفة لتسليط الضوء على التوترات النفسية بين الإنسان والحياة، بلغة رومانسية. ينتمي "عيساوي" بوضوح إلى هذه الفئة، استنادا إلى إشارات تتعدّى العنوان "نصف قبلة وفخذ"، لنجد مفهوم الثنائية شائعًا في كل من العبارات.
يتحدّى، الكاتب في نصوصه، رغبتنا في صورة مبسطة :"حنجور الأبجديّة مع كوب الحبر. ثمانية وعشرون حبّة أزدردها جرعة أخيرة. أنا والآلهة: مَن يزهق مَن؟". يستخدم "عيساوي"، بشكل فعّال، فواصل الأسطر للتذكير المرئي بالفضاء الشخصي، لتشكّل مزيجًا إنسانيًّا كليًّا من المودّة والعدوان. ويدرك أنّ مزيدًا من التوضيح للنص الفرعي ليس ضروريا، خاصة مع ما تعانيه هذه الخطوط الأكثر بروزا من المقارنة مع الصور القوية التي تسبقها، تمهيدًا للحصول على فكرة الذات كحدود أخرى، دون سحب القارئ إلى مجموعة جديدة من الاستعارات، لتصبح معها أفكار الكاتب أقل شفافيّة، كما يتضح مع الانتقال قدما من نص إلى آخر.
إنّ ديوان العيساوي الأخير، يمزج بين الوقائع والأدوات الأدبية والتاريخية لتصوير الأحاسيس المباشرة لإنسان هذا العصر، ولكنّ الأسلوب الذي يعتمد عليه لشرح هيمنة الصور الميكانيكية تشير إلى أنّ الصراع المعاصر هو مجرد تقليد ساخر لمعارك أكثر بطوليّة من الخمول. ولعلّ المزيد من تطوّر الشخصية والصراعات الداخلية، تتخلّلها المؤثرات الخارجيّة، من شأنه أن يجعلنا نتأمّل اهتمامات الإنسان المعاصر: هل شعر بخيبة أمل، خجل، عجز، راحة، انتصار؟ بعض خليط غامض من أعلاه؟
فالنصوص الحيّة، ذات المزايا الشعريّة الواضحة، تقودنا مباشرة إلى مشهد من الظلام والصراع، ما يشير إلى تطوّر عكسي يحوّل الحضارة إلى انحطاط، كما إلى افتقار الإنسان إلى الثقة بنفسه. لنعثر على قصائد تساعد جمهورها الحديث على فهم الأهمية السياسية والأخلاقية والشخصية للتطوّر. نصوص الكاتب تصوّر بخبرة التجريد من الإنسانيّة والعجز اللّذين أصبحا ركيزة العصر. ولكن بعد ذلك يتركنا فقط في هذه المرحلة، من دون فهم جديد للدروس المستفادة من هذه التجارب. وهذا ما يميّزه. لأنّنا، وبعد تعقب السرد الأدبي في نصوصه، نستطيع أن نقدّر التعقيد الخفي، إذ نستجيب للقصيدة بقوة من القراءة الأولى، لأنّها تلمسنا، قبل النظر فيها ثانية محاولين استبطانها.
من ناحية أخرى، لم يلجأ الكاتب إلى اعتماد أسلوب الأسطر الأخيرة التي تفسّر معنى النص، وأعتقد أنّه ينهي نصوصه بشكل جيد، من حيث التمدّد والتقاط الصورة النهائية القوية. والعنصر الآخر الذي يمرّ على الديوان هو أنّ بضعة نصوصه تفتقر إلى الزخم الإيقاعي الذي يبرز أكثر في نصوص أخرى، وتقع في مسيرة قوية ومنظمة: تخفيف الإيقاع حيث يجب ذلك، مع إضافة المزيد من الصور الشعرية والعمق النفسي، ثمّ يتمّ كسر هذا النمط من خلال إدراج إيقاعات المحادثة، بشكل سريع ومعقد، معتمدًا حروفًا ساكنة ومحكمة بشكل حاد، فتساعدنا الأصوات المفتوحة والمشرقة على الشعور بالهدوء. لتبدو بذلك نصوص "نصف قبلة وفخذ" تماما كأغنية تستمع لها آذان حديثة، حيث تقدّم القصيدة نفسها كما الآية الحرة، حرّة.
مثل العام الجديد، الديوان الجديد هو بداية جديدة، ولكن أيضا تذكير غير مرحّب به أنّ الوقت يمر، لتتبدّل الكتابات، ومواضيع اهتمامها، وفي نهاية المطاف تنشأ أفكار جديدة قد تكون مغايرة تماما لما سبقها.